-
℃ 11 تركيا
-
12 مايو 2025
عبد الباسط سيدا يكتب: تطلعات الشعوب بين تراجع الديمقراطية وشراسة الاستبداد
عبد الباسط سيدا يكتب: تطلعات الشعوب بين تراجع الديمقراطية وشراسة الاستبداد
-
16 يناير 2022, 10:34:58 ص
-
 1029
1029 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
يواجه النظام الديمقراطي على المستوى العالمي تحديات كبرى، تتمثل في تصاعد الخطاب الشعبوي والعنصري المكشوف، وانتشار الفساد في الكثير من الدول الديمقراطية، بما فيها تلك المستقرة الناضجة قياساً إلى تلك الديمقراطيات الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولا يقتصر هذا الفساد على الداخل وحده، بل يشمل ذاك العابر للحدود، الذي يأخذ شكل العمولات وأجور الاستشارات، والرشاوى التي تُدفع لتسهيل عقود الصفقات وتمريرها.
وأصحاب الفساد والمستفيدون منه لا يلتزمون عادة بالمعايير الأخلاقية، ولا تردعهم القوانين المعلنة، لأن معظم الصفقات التي تتم تكون سرية الطابع بذريعة الحفاظ على مصالح وأسرار الدولة. وحينما يُكتشف أمرها في بعض الأحيان، تبذل الجهود سريعاً للتغطية عليها، وإبعادها عن دائرة الضوء. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الميدان حول صفقات بين شركات غربية مع أنظمة استبدادية، وحتى مع جماعات مصنفة إرهابياً وفق اللوائح المعتمدة في الدول التي تتبعها تلك الشركات؛ وكل ذلك يثير الكثير من التساؤلات والشكوك، ويعزز مكانة أصحاب نظرية المؤامرة الذين يرون أن الأمور هي محددة ومقررة سلفاً ليس على مستوى كل دولة فحسب، بل على المستوى الكوني بأسره. فهناك أصحاب الشركات المتعددة الجنسيات، وأرباب المال، وأركان الدولة العميقة، والوسطاء من جماعات الضغط، الذين يدفعون باتجاه اتخاذ القرارات التي تمكنهم تحقيق المزيد من الأرباح، ورفع درجات الهيمنة.
وكل هذا يدفع بعدد كبير من المواطنين نحو الإحباط واليأس، فيمتنعون عن أداء واجباتهم، أو يتحولون إلى مجرد مواطنين سلبيين لا يشاركون في اللقاءات والمناقشات العامة؛ ولا يساهمون في عملية الدفاع عن القضايا أو المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع، بغض النظر عما إذا كانت كبيرة أو صغيرة. فمثلاً في الأحوال العادية لا بد أن ينتقد المواطن في المجتمع الديمقراطي ما تتعرض له وسيلة إعلامية من ضغوط قد تمس باستقلاليتها، أو ينتقد القرارات التي تضعف استقلالية القضاء. ولكن حينما يُصاب هذا المواطن بالإحباط، وينسحب ليتخذ الموقف الانفعالي المنعزل، ويتعامل مع ما يجري، وكأنه لا يعنيه، ولا يمس مصيره ومصير الجيل المقبل؛ بل يشكّك في إمكانية التغيير، وبالتالي يُقنع نفسه، ومن يستطيع أن يؤثر فيهم، بعدم جدوى بذل أي جهد لتحقيق التغيير نحو الأفضل، فهذا معناه أنه قد خرج من دائرة الفعل، وقَبِل بأن يتم تحديد دوره ومستقبله من جانب أولئك الذين لا يثق بهم، ولا يجسدون بالنسبة إليه أي أمل.
هل ستدرك الأنظمة الديمقراطية في نهاية المطاف أن مصلحتها الفعلية على المدى البعيد تتمثل في دعم تطلعات الشعوب واحترامها؟ لأن ذلك لو تحقق فإنه سيؤدي إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب، ويضع حداً لقوافل المهاجرين، وسيحقق الأمن والاستقرار.
وتصبح المصيبة أكبر حينما يتحول هذا التوجه الفردي إلى ظاهرة عامة، تستغلها القوى الشعبوية عبر دغدغة العواطف وإثارة النزعات العنصرية أو الدينية. وما يتكامل مع هذه التوجهات الشعبوية يتمثل في ضعف الأحزاب التقليدية التي عجزت عن تطوير برامجها لتراعي المتغيرات المستجدة، كما لم تتمكن من تجديد بنيتها التنظيمية عبر استقطاب المزيد من الشباب. وهذا ما نشهده اليوم في العديد من الدول الغربية يتجلى في ظاهرة عزوف الشباب عن الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وهي الأداة التي من المفروض أنها ستمكنهم من الوصول إلى المواقع القيادية بناء على قواعد اللعبة الديمقراطية، كأن يكونوا مثلاً في البرلمان، أو الحكومة، أو حتى الرئاسة.
النظام الديمقراطي لا يقوم على الانتخابات وحدها مهما كانت حرة ونزيهة، بل يحتاج إلى جملة ركائز أخرى، لا استغناء عنها من أجل استمرارية هذا النظام، وتمكينه من مواكبة المتغيرات والمستجدات؛ وفي مقدمة هذه الركائز تأتي أهمية، بل ضرورة، وجود معارضة نشيطة تمارس عملها بكل جرأة وفق قواعد وضمانات يقر بها الدستور، ويلزم بضرورة مراعاتها والأخذ بها. كما أن النظام الديمقراطي يستوجب وجود صحافة حرة تمكّن المواطنين من الاطلاع بكل شفافية على ما يجري، الأمر الذي سيمكّن من المتابعة والمساءلة والمحاسبة، وفق قواعد واضحة محددة بقوانين ومبادئ دستورية. وهذا كله لن يتم من دون وجود قضاء مستقل، يستطيع أن يمارس أعماله بكل حرية، ويصدر الأحكام العادلة التي لا تخضع لأي ابتزاز أوضغط وتدخل سواء من جانب السلطة، أم من قبل جماعات الضغط بمختلف أشكالها ومسمياتها.
أما التحدي الأخطر الذي تواجهه الأنظمة الديمقراطية، بما فيها المستقرة، فهو يتمثل في أصرار السلطات الاستبدادية على تسويق نماذجها، خارج حدود دولها، سواء عن طريق التدخل العسكري المباشر أم غير المباشر، أو عن طريق نشر المعلومات المضللة، والسعي المتواصل من أجل التأثير في توجهات الناخبين في الدول الديمقراطية، ودعم الأنظمة المستبدة التي تواجه انتقادات وحركات احتجاجية، وحتى ثورات شعبية تدعو إلى الإصلاح وإلى عمليات تغيير سياسية جدية، تحترم إرادة الشعوب وتطلعاتها.
فما حصل في العديد من الدول العربية من دعم للأنظمة التي ثارت عليها شعوبها، يؤكد حرص القوى الاستبدادية على مساندة بعضها بعضاً، وذلك لتيقنها من أن أي نَفس ديمقراطي في أية بقعة من العالم سيؤثر عليها سلباً عاجلاً أم آجلاً. هذا ما جرى، ويجري، في سوريا ولبنان والعراق واليمن؛ ويجري في السودان وليبيا وتونس؛ كما حصل، ويحصل، أيضاً في أوكرانيا وكازاخستان، والعديد من الدول الأمريكية اللاتينية والآسيوية والأفريقية، ونشير هنا على سبيل إلى تايلاند وميانمار، وقبل ذلك في إيران.
الأنظمة المستبدة تراقب الأوضاع في الدول الديمقراطية عن كثب، وهي مطلعة على الثغرات الموجودة في أنظمة تلك الدول؛ كما تدرك أن الحسابات الانتخابية باتت هي الشغل الشاغل لمختلف الأحزاب السياسية التي تحاول بشتى السبل أن تفوزبالأغلبية، أو أن تتمكن من تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى بغية الوصول إلى السلطة، لذلك فهي مستعدة للمهادنة مع الأنظمة الاستبدادية، أو تغض النظر عن تجاوزاتها، مقابل الحصول على امتيازات أو صفقات تروجها بوصفها انجازات تستثمر في لعبة تضليل الناخبين، وإقناعهم بقدرتها على تلبية احتياجاتهم، سيما من جهة تأمين فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية.
من ناحية أخرى باتت فزّاعة الإرهاب الكنز الذي لا ينضب بالنسبة إلى الأنظمة الاستبدادية، فهي تضلل شعوبها عبر رفع شعارات مكافحة الإرهاب؛ والمحافظة على الاستقرار، كما جرى في كازاخستان التي اتهم رئيسها قاسم جومرت توكاييف مواطنيه المحتجين على الظروف المعيشية الصعبة، على الرغم من ثروات البلاد، بالعمالة والإرهاب، وأمر بفتح النار عليهم من دون سابق انذار. ولم يكتف بذلك، بل طلب تدخلاً روسياً تحت غطاء قوات «حفظ السلام» التابعة لـ «منظمة معاهدة الأمن الجماعي». ودخلت القوات الروسية لتسحق حركة الاحتجاج، لكن اللافت في الأمر هو إعلان الرئيس الروسي بوتين بكل وضوح بأنهم لن يقبلوا بأية ثورات ملونة، وهذا ما أصاب مصداقية الرئيس الكازاختساني في الصميم. فما أفصح عنه بوتين يؤكد أن اللعبة قد باتت على المكشوف. فروسيا اليوم تعلن بكل صراحة أنها لن تسمح للأوكرانيين باتخاذ القرارات السيادية التي تخصهم، كما أنها تهدد الجورجيين، وحتى الفنلنديين. كما تؤكد على لسان مبعوثها الرئاسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن سلطة بشار الأسد باقية في سوريا، ويدعو «اللجنة الدستورية» الإشكالية أصلا إلى شرعنة ذلك.
هل ستدرك الأنظمة الديمقراطية في نهاية المطاف أن مصلحتها الفعلية على المدى البعيد تتمثل في دعم تطلعات الشعوب واحترامها؟ لأن ذلك لو تحقق فإنه سيؤدي إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب، ويضع حداً لقوافل المهاجرين، وسيحقق الأمن والاستقرار. كما أنه سيفتح الآفاق أمام علاقات اقتصادية متوازنة، أساسها المصالح المشتركة التي تستفيد منها الشعوب لا مافيات الفساد. وكل ذلك سيساهم في تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في ميادين البحث العلمي، ومكافحة الأوبئة، ومواجهة تحديات وتبعات آفة المخدرات، والحفاظ على سلامة البيئة.
نتمنى ذلك، مع أن الوقائع والمعطيات الراهنة لا تبشّر بكل أسف.
*عبد الباسط سيدا ... معارض سوري من أصل كردي، خبير في الحضارات القديمة، وصاحب مؤلفات عدة في المسألة الكردية والفكر العربي.
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "180 تحقيقات"

 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 ثلاثاء, 28 فبراير 2023
ثلاثاء, 28 فبراير 2023 
 خميس, 05 يناير 2023
خميس, 05 يناير 2023 



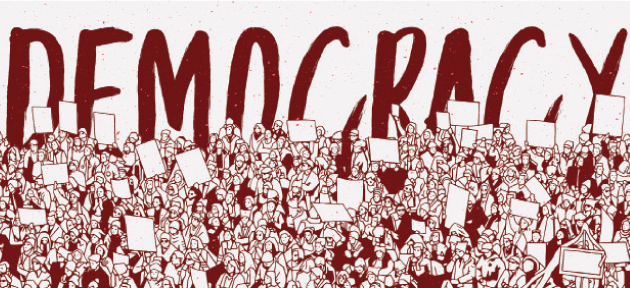
 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 



