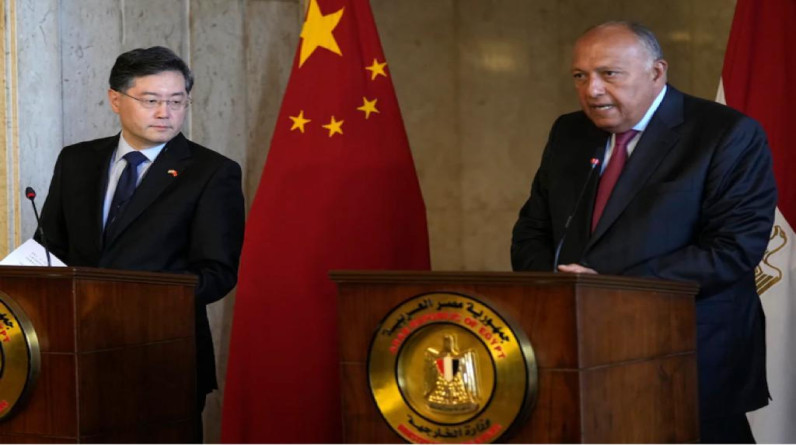-
℃ 11 تركيا
-
4 مايو 2025
منصف الوهايبي يكتب: أفريقيا أم رقصة بامبولا
منصف الوهايبي يكتب: أفريقيا أم رقصة بامبولا
-
18 يونيو 2023, 6:13:07 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
يرى بعض فلاسفة التاريخ أنّ كلّ مشروع استعماري ينهض على ثلاثة عناصر متوافقة مترابطة: فهو تمرّس ومنظومة معارف أو مدوّنة معرفيّة، وهندسة تهدف إلى إعادة صياغة العقل أو «هندسة عقليّة» بعبارة هؤلاء، تشمل المستعمِر (بكسر الميم) والمستعمَر مع (بفتح الميم). وعلى أساس من هذا، يخلص هؤلاء بداهة إلى أنّ الخلاص من الاستعمار، يقوّض هذه البنية الثلاثيّة، بما يفضي احتمالا، إلى الاستقلال والتحرّر والعدالة الاجتماعيّة؛ بل تحرير المستعمِر نفسه من إرثه الاستعماري.
على أنّ متابعة ما يحدث في عالم اليوم في أوروبا وفي فرنسا تحديدا ـ كلّما تعلّق الأمر بأفريقيا – تؤكّد أن لا أحد من قادتها يمتلك رغبة صالحة في إصلاح جذريّ للعلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة. وكلّنا يتذكّر جولة الرئيس نيكولا ساركوزي سيئ السمعة، في أفريقيا جنوب الصحراء أوّل مرّة، فقد سبقته قبل أن تنزل طائرته في داكار، سمعة السياسي الخطير والساخر الفظّ المتعطش للسلطة، الذي لا يبخل على أفريقيا والأفارقة بالازدراء، والطعن فيهم والعيب. ربّما كان البعض مفتونين به كما فتنهم ماكرون لاحقا، أو توسّموا فيه الحنكة والذكاء السياسي؛ أو «هلّلوا» لتعيينه بعض وزرائه من أصل أفريقي، واعتبروا ذلك دلالة على مجتمع متعدّد الأعراق، أو هو ذو بعد عالميّ، أو هو يستعيد أبهى ما في مأثورات الثورة الفرنسيّة.
غير أنّ ردود الفعل المسجّلة هنا وهناك، في الصحافة والقنوات الإذاعيّة والتلفزيّة ومواقع الاتصال، وهي اليوم أشبه بـ«اللوح المحفوظّ» الذي يحفظ مقادير الخلق ومشيئتهم، ويجعل التاريخ حيّا معاصرا، بيّنت خواء سياسته ومزاعمه المتهافتة؛ بل «صدمت» الأفارقة وخاصّة الشباب منهم، بدءا بهذا «الاغتصاب اللغوي» الذي مردّه إلى الفرنسيّة «اللغة الغنيمة» التي تضفي على نفسها «قداسة» أو هي تستثني نفسها بذريعة الصداقة المتقنّعة بـ«الأبويّة»؛ وهي شأنها شأن كلّ لغة تصلح لكلّ شيء، بما في ذلك التدليس والتزوير، والقسوة على «الأضعف»؛ بل الأذى المقصود أو اللاواعي وهو ليس من فلتات اللسان وزلّاته. وفي «صراحته» أو «صدقه» أو «فظاظته» و«سلاطة» لسانه، سلط نيكولا ساركوزي الضوء على ما لم يُقل حتى الآن، بل «أظهر» المضمر الفكري الذي تقوم عليه سياسة فرنسا الأفريقيّة قلبا وقالبا؛ وكأنّه يعود بنا إلى نهايات القرن التاسع عشر، وإلى تراث فكريّ، يتوهّم جلّنا أنّ الزمن عفّى عليه، وطواه النسيان أو «ما بعد الاستعمار» في ما يطوي. و«الإنسان الأفريقي» في منظور ساركوزي، يُعرّف ويُعرف في ضرب من جدليّة النقص وعدم الاكتمال، من خلال ما ليس لديه، أو بما لا يملكه، أو بما لم يفلح في تحقيقه؛ أو من خلال مقارنته بما ليس هو أي «الإنسان الحديث» وهي العبارة التي تخفي «الرجل الأبيض» كما يخفي أو يحجب «الأب الشرعي» «أبا غير شرعيّ» أو «كما يحجب القطار قطارا آخر» في العبارة المجازيّة المتداولة.
وهي ليست غير استعادة لرؤية هيجل لأفريقيا أرض الجوهر القابع الثابت غير المتحرّك، والخلق البهيج والأسيّ في آن، حيث الزنوج هم أنفسهم أمس واليوم وغدا، محكومون بسلطة الطبيعة، وليس بأفكار الحرّيّة والعدالة والتقدّم؛ واقفون على أعتاب التاريخ صورة من «الطبيعة البشريّة» في بدائيّتها، أو هم يدورون أبدا في أغلال التكرار والأسطورة؛ أو يرقصون «البامبولا» على وقع الطبول الأفريقيّة صورة من «المناوِش» السنغالي أو الأسود، بتلك الدلالة العنصريّة التي ينطوي عليها مصطلح «الزنجي» مثل «المساعد» الذي يعدّ أو هو يكتب أثرا أدبيّا أو فنّيّا لغيره، أو ما توصف به كلّ لغة فرنسيّة رديئة، أو أيّة مذكّرة ملتبسة العبارات، أو عبارة الأمهق الزنجي [«زنجي» أبيض] بترجمة الكناية حرفيّا وهي طبعا لا تستقيم.
أدرك مثل كلّ هؤلاء الذين قرأت لهم من الذين لا يتهيّبون الدفاع بصوت عالٍ عن فكرة الأمّة «غير المرتهنة» لتاريخها الاستعماري، أنّه لا بدّ من تنسيب الحكم ما تعلّق الأمر برؤية أفريقيا في المنظور الاستعماري أو ما يسمّى «التحيّز» الهيجلي، عند ديغول أو بومبيدو أو جيسكار ديستان أو ميتران أو شيراك… فربّما كان «تحيّزهم» أقلّ وطأة؛ أو أكثر مكرا، وهم الذين تحاشوا الصدام المباشر مع محاوريهم من الأفارقة، أو عند أطياف اليسار الفرنسي المستنير، أو الذين تحرّروا بنسبة أو بأخرى من السرديّة التي صاغتها الإثنولوجيا الاستعماريّة في نهايات القرن التاسع عشر، أو من «الغرائبيّة» التي «تتمثّل» أحد الوجوه المميّزة للعنصريّة على الطريقة الفرنسيّة، بعبارة بعض هؤلاء.
في هذا السياق، تستعاد قراءة رؤية هيجل لأفريقيا والأفارقة، تلك التي تضافرت في صياغة سرديّتها شتّى روايات كلّ الذين مهّدوا للاستعمار من مبشّرين ومستكشفين وجواسيس في القرن التاسع عشر. ذكر هيجل في محاضراته أنّه لا وجود في أفريقيا للسمات الأساسيّة التي تميّز «المجتمعات التاريخيّة» بعبارته، بل هي الصورة الأنموذج للاعقلانيّة، والمعتقدات الدينيّة القائمة على السحر، وللإنسان الطبيعي بكلّ همجيّته أو حدّته، المحكوم بأهوائه ورغائبه لا غير.
ومثل هذا التصوّر الديني «الأفريقي» ممّا يحدّ في منظوره، من قدرة الأفارقة على تطوير «الوعي بشيء أسمى»، إذ تختلف مجتمعاتهم عن المجتمعات التي ترسّخت فيها المسيحيّة مثل الجرمانيّة؛ فهذه وحدها تحافظ على وعودها التاريخية، وتهب الإنسان حرّيّته الروحيّة. فليس بالمستغرب إذن أن يقرّر أنّ غياب الدول العقلانيّة الحديثة في أفريقيا، ممّا يضعها خارج سياق التقدّم التاريخي؛ ما دام إنشاء الدول دلالة اختبار على تطوّر الروح والنضال من أجل الحرّيّة والفنّ والقانون والعادات والدين والعلم.
تجسّد أفريقيا في تقدير هيجل، كلّ ما هو غير متحضّر أو غير متمدّن، وهي قارّة لا تزال «مغلقة»، وغير مرتبطة ببقيّة العالم. إنّها واقعا ومخيالا أرض الذهب المنطوية على نفسها، وأرض البدايات [طفولة العالم] التي يلفّها لون الليل الأسود بمعزل عن التاريخ الواعي.
هذه الصورة الهيجليّة لشعب أفريقي غير متمايز عن الطبيعة، هي كيفما أتيتها، وتسقّطت لها من المعاذير، مهينة للغاية. صحيح أنّ ما يميّز البشر هو أنهم يعارضون الطبيعة التي هم جزء منها، ويقاومونها، ويقومون بمحاكاتها وبتعديلها بما يتناسب مع احتياجاتهم. وهذا يظهر في أبسط أعمال زراعة النباتات وغراسة الأشجار الصالحة للأكل، وتخزين البذور، وتدجين الحيوانات؛ وليس الاكتفاء بجمع النباتات البريّة، والاعتماد على الصيد؛ من أجل توفير القوت. وفي سياق منازلة الطبيعة يصنع البشر طبيعتهم الاجتماعيّة، ومن ثمة يصنعون تاريخهم. وهذا سائغ مقبول، وجميعنا يقرّ به؛ وهو ممّا تعلّمناه من دروس الفلسفة، ومن النصوص الأدبيّة وغيرها، لكن استثناء أفريقيا منها وخاصّة السوداء، يصوّر الأفارقة همزا ولمزا في هيئة الحيوانات التي «تتكيّف» مع الطبيعة، وتظلّ جزءًا غير متمايز منها. وكأنّهم لا يصنعون التاريخ، أو هم يعيشون خارجه أو على حافّته.
ولذلك فإنّ اعتراض المعاصرين على هذه الرؤية الهيجليّة «الهجينة» وجيه جدّا، لا سيما في سياق مشروع هيجل الذي يعتبر التاريخ حرّيّة في حالة حركة. وإذا كان الأفريقي خارج التاريخ، فهو إذن عبد لا أكثر ولا أقلّ. وإذا كانت العبودية هي حالته الطبيعيّة، فإنّ استعباد الأوروبيين للأفارقة، في المنظور الهيجلي، يغدو أنموذجًا عاديا أو هو شبه أخلاقي؛ بل هو في صالح الأفارقة أنفسهم؛ خاصّة أنّ «مؤسّسة العبوديّة» في هذا المنظور، لها ما يسوغّها أخلاقيًا، ما دامت قائمة في إطار الدولة. وهي من ثمّة «لحظة تطوّر، ومستوى من التحصيل المعرفي، ونوع من المشاركة في الأخلاق السامية والثقافة المرتبطة بها…» وعليه فإن الإلغاء التدريجي للعبوديّة هو أكثر ملاءمة وعدلاً من حظرها بجرّة قلم. ومن مفارقات التاريخ أنّ هذا ما كان يقول به العرب المسلمون، من أجل تسويغ العبوديّة، قبل أن يبادر أحمد باشا باي تونس عام 1846 بإلغاء العبوديّة والرقّ.
ثمّة إذن أكثر من أفريقيا: أفريقيا الكذبة القائلة بأنّ الاستعمار كان في جوهره مشروعًا حضاريّا ساهم في تحديث المجتمعات الأفريقيّة التي لم تتطّور لانعدام وجود دولة، بما يشير إلى «سبات بشري» المختلف عن «سبات حيوان»، لأنّ «الإنسان الحيوان» كالطفل الذي لا يعقل، ولكن يمكن أن يصبح عقلانيًا؛ بينما لا يملك الحيوان أيّ إمكان لإدراك نفسه.
وثمّة أفريقيا «النخب الفرنسيّة الجديدة» الريفيّة الساحرة التي يتعايش فيها الأحياء والأموات الذين لم يفقدوا أصواتهم في فوضى «بابل الأصوات»، والآلهة التي تغنّي في الأنهار وتختبئ في الأدغال. وثمّة أفريقيا الأفريقيّة التي يكتبها أبناؤها، وهم لها وعليها: أفريقيا سوينكا وكريستوفر أوكيغبو وجي بي كلارك وتشينوا أتشيبي وغيرهم من الذين أرسوا أسس التقاليد الأدبيّة الأفريقيّة المناهضة للعبوديّة والاستعمار، الناطقة بالإنجليزيّة والفرنسيّة مثل سنغور وإيمي سيزار وديوب؛ في ما اصطلح عليه بـ«الزنوجة» التيّار الأدبي والسياسي المعروف.
أمّا استثناء هيجل مصر والشمال الأفريقي عامّة، فلا بدّ له من رقصة بامبولا أخرى.

 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 ثلاثاء, 22 أبريل 2025
ثلاثاء, 22 أبريل 2025 
 جمعة, 18 أكتوبر 2024
جمعة, 18 أكتوبر 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب