-
℃ 11 تركيا
-
12 مايو 2025
أحمد عزالدين : عن ثورة يوليو وجمال عبد الناصر أى ميراث نجحد ؟!
أحمد عزالدين : عن ثورة يوليو وجمال عبد الناصر أى ميراث نجحد ؟!
-
1 أغسطس 2021, 10:53:03 م
-
 1269
1269 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
فى أوج لحظة انهيار الإمبراطورية السوفيتية ، وصعود ( يلسن ) إلى السلطة ، خرجت مجلة ( بلاى بوى ) الأمريكية وعلى غلافها صورة لشاب وشابة إلى جانب مرقد وتمثال ( لينين) قائد الثورة الروسية وهما يمارسان الجنس شبه عاريين ، وقد كانت الدلالة المباشرة واضحة ، أن مرقد ( لينين ) وتمثاله ، الذى كان يتطلب المرور عليه ، الوقوف لساعات ، قد أصبح مهجوراً ، حتى أنه غدا مكاناً يمارس فى ساحته ، ما يمارس فى غرف النوم المغلقة ، وأن هذا التمثال فضلاً عن ذلك لم يعد غير قطعة متآكلة من الحجر ، يدبّ من حولها نبض الحياة الجديدة ، على الطريقة الأمريكية ، ثم كانت الدلالة الأعمق فى النهاية ، بمثابة إعلان مدو لا عن هزيمة الثورة الروسية وقائدها ، وإنما عن هزيمة وانهيار ودفن الأمة الروسية ذاتها ، مع قطعة ثورية حّية من تاريخها.
لكن العقل السياسى الروسى أدرك بعمق منذ البداية ،أن التاريخ القومى لروسيا ، لا ينفصم ولا يتجزأ ، وأنه ككل تاريخ قومي آخر ، نهر بلا فواصل ولا قواطع ، ولهذا فإن روسيا التى لم تعد ماركسية أو لينينّية أو إشتراكية ، قررت أن تصنع هذا العام من حدث مرور مائة عام على الثورة البلشفيّة ، بعلمها الأحمر ، وبمنجل ومطرقة لينين ، أكبر احتفالية رسمية وشعبية فى التاريخ الروسى الأمر نفسه يمكن أن تراه مكرّراً فى فرنسا مع كل احتفال بالثورة الفرنسة ، حيث تتزيّن باريس بكل ورودها وعقودها ، وتبدو وكأنها اغتسلت فى مياه السين ، وتعطرت بعبق التاريخ ، وكأنها تنتظر عشاقها القادمين من فجاج تاريخها ، وقد توحدّت بأجيالها وتياراتها السياسية والفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، ومن قمة السلطة إلى سفح المجتمع.
وفى احتفالات روسيا أو فرنسا بالثورة لا تُركز الأعين على الأخطاء والسلبيات ، فلا أحد فى فرنسا يستعيد مقصلة الجيلاتين ، ولا برك الدم المسفوك فى الشوارع ، ولا أحد فى روسيا- أيضاً- يركز على عمليات القتل المنظم ، والتصفيات التى تجاوزت الحدود لكل من يحمل شبهة مضادة للثورة .
لأن التركيز فى كل الأحوال ، لا يتم إلا على تلك العصارة الثوريّة الحّية ، التى اندفعت لتجدد شباب أمة ، بأبنيتها الإجتماعية والإقتصادية والفكرية قبل السياسية ، وانعكست بالتالى على المكانة والدور.
عندنا فى مصر يبدو الأمر عكس ذلك ، وتبريره بجرحى الثورة المصرية ، ينطوي على مفارقة ، إذ أن جرحى ثورة يوليو لا يساوي فى ميزان التاريخ ، عوداً واحداً فى حقول قتلى الثورة الفرنسية ، أو ضحايا الثورة الروسية ، وحتى لو كان الأمر جراحاً وضحايا ، فمن قبيل منطق الطبيعة أن النار تبرد بمرور الوقت ، وأن الجروح تزداد التئاماً بمرور الزمن ، لكن عندنا تعمل قوانين الطبيعة ضد الطبيعة ، فتزداد الحملات المنظمة ضد الثورة ، وضد قائدها جمال عبد الناصر ، كلما تعاقبت السنين ، وتراكمت العقود ، وتدافعت المتغيرات ، وكأن ثورة يوليو ما تزال هى المحيط الصحراوى القاحل الذى يحاصر مصر ، ويلف أذرعه عليها ، ويمنعها من أن تعانق المستقبل.
والمؤسف فى ذلك - أولاً - أننا نتكلم عن ثورة جرى تصنيفها فى كل مدراس البحث العلمى والدراسات التاريخية الغربية ، على أنها واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الإنساني كله ، ليس بحكم ما أحدثته فى البيئة الداخلية المصرية ، من المتغيرات العاصفة فى بنية المجتمع ذاته ، وفى هياكله الدفاعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية فحسب ، وإنما بحكم تلك الزلزلة التى أحدثتها فى المحيطين الإقليمي والدولى ، وسواء تم الحديث عن رياح الثورة التى هزت أفريقيا كلها ، ووصلت أصداؤها إلى أمريكا اللاتينية ، أو عن مردودها العميق التأثير فى المحيط الدولى كله ، فقد نازلت الظاهرة الاستعمارية وأسقطتها بعد أن امتدت خمسمائة عام ، وتمكنت دولة واحدة فى إهابها مثل بريطانيا أن تحتل مساحة من الكرة الأرضية قدر مساحتها مائة وستة وثلاثين ضعفاً ، وقد تحولت على يديها من إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ، إلى مجرد دولة تابعة للامبريالية الصاعدة الجديدة .
ولهذا قد يري البعض أن ثورة يوليو قد غيرت فى بيئة الإقليم والعالم ربما أكثر مما غيرت فى بيئتها ، وهذا سبق فى التاريخ لا يدانيه سبق ، وريادة تحظى باعتراف سياسى وأكاديمى ساحق ، وموروث عظيم ينبغى العضّ عليه بالنواجز ، ولذلك فإن أولئك الذين يطعنون فى الثورة ، ودورها وتأثيرها سبقاً وريادة وإعادة بناء لموازين القوى الإقليمية والدولية ، وينكرون ميراثاً وطنياً عظيماً ، إنما يشكل إنكاره وجحده مزيجاً يتراوح بين سوء التقدير وسوء الفهم ، وبين سوء النية وسوء القصد.
والمؤسف فى ذلك - ثانياً - أن الذاكرة التاريخية ، وفى القلب منها الذاكرة العسكرية ، هى أكثر العوامل تأثيراً فى صنع الثقافة الإستراتيجية ، فالثقافة الإستراتيجية لشعب من الشعوب ، هى التعبير المباشر فى فترة من الزمن عن ذاكرته التاريخية .
ولذلك فإن التعتيم على مرحلة تحول كبرى ، مشبعة بالمتغيرات والتحديات والمعارك ، وذمّها وتحقيرها برجالها وانتصاراتها وهزائمها ، ليس عملاً من أعمال العقل ، وإنما من أعمال الغواية ، لأن نتائجه إنما تنصبّ ، بالسلب فى درجة سطوع ووضوح الثقافة الإستراتيجية للشعب ، باعتبارها أهم الأسلحة ، فى لحظة صراع تاريخى بالغ الشدة والحدّة ، هو فى جوهره صراع وجود.
والمؤسف فى ذلك - ثالثاً- أن هذه الحرب الطاحنة ضد ثورة يوليو ، لم تكن وقفاً عليها ، وإنما شكّلت ما يشبه القانون الطبيعى ، ضد كل ثورة مصرية فى التاريخ الحديث والمعاصر .
لقد تفردّ الشعب المصرى ، بأن فجّر وقاد خمس ثورات كبرى ، خلال قرنين من الزمن ، وإذا كان ذلك يشكّل علامة طاقة لا تنفذ ، وصلابة لا تلين ، وإصراراً لا يقبل المصادرة ، فقد كان الجيش المصرى حاضراً بقوة العقيدة قبل قوة السلاح جسداً وروحاً ، فى كل واحدة من هذه الثورات ، من عرابى حتى 30 يونيو ، باستثناء ثورة 1919 ، لأن جسد الجيش كان محتجزاً وراء الحدود فى السودان ، وهذا ما لم يمنع من مشاركة طلاب المعاهد العسكرية فى قلب موجتها ، غير أن كل هذه الثورات نالت نصيبها من الحرب عليها بترسانة من الأكاذيب والفتن والدعاية المضادة ، وكأن المطلوب طول الوقت هو شطب كلمة الثورة نفسها من القاموس ، وقد فعلها ( فوكوياما) صاحب نظرية نهاية التاريخ ، لكنه لم يجرؤ على أن يشطب الثورة من التاريخ ، وإنما شطبها من المستقبل ، قبل أن يجئ رد التاريخ حاسماً على يد المصريين بأن الثورات لا تلغى ، فضلاً على أنها لا تنسخ أو تستنسخ .
وإذا كانت حروب الثأر ضد الثورات فى التاريخ المصرى قد أنطفأت ، ولم يبق منها الإ حروب الثأر ضد ثورة يوليو ، إلا أنه يخيّل إليك بعد عقود طويلة أنها حروب ممتدة ، وكأن نار يوليو قد أُضرمت الآن ، وأن جرحى يوليو هم عموم الشعب المصرى ، وأن هذا الشعب لم يكن صانع الثورة ،وملهمها وقائدها ، وإنما كان فى مقدمة ضحاياها ، ولهذا فإن هدف هذه الحرب ليس شطب الثورة من التاريخ ، فهذا أمر يفوق خيالات أصحابها ، ولهذا - أيضاً - لا شئ فى هذه الحرب بالمعنى الحقيقى ، معنىّ بما كان ، وإنما بما سيكون ، ولا شئ فى هذه الحرب موجّه إلى الماضى وإنما إلى الحاضر والمستقبل .
والمؤسف فى ذلك - رابعاً - أنه لا شعب يمتلك مثل هذا العمق الحضارى التاريخى كالشعب المصرى ، ولا شعب يمتلك فى عمق هذا العمق الحضارى التاريخى، ميراثاً هو الأغنى ، من المعرفة والتضحية والفداء والتجربة والصواب والخطأ ، فضلاً عن أن هذا العمق الحضارى التاريخى ، ظل يمثل منجماً مفتوحاً لحالة وطنية فريدة ، أسمها " الخصوصية المصرية " تحسّها دون أن تمسكها ، وتدركها دون أن تبصرها ، وترى نتائجها وأثارها دون أن ترى مقدماتها ، وتفاجئك فى كل مرة ، كأنها قادرة على أن تجدد نفسها فى كل دورة ، فهى الخصوبة وقت الجدب ، وهى الفيضان فى ذروة الجفاف.
وقد يبدو مدهشاً أن صورة جمال عبد الناصر فى الوجدان الجمعى المصرى ، قد تعرضت على امتداد ما يقرب من نصف قرن ، إلى قذائف متصلة من مساحيق الإذابة ، وإلى قنابل متتالية من مركبات الحقد والكراهية ،وأنها جميعها فى النهاية ، لم تترك أثرا يزيد عما تتركه قنابل الدخان ، التى سرعان ما يتبدد ، لتبق الصورة على حالها ، بل لتنبسط وترتفع فى لحظات الإنشداد والمواجهة والتغيير فى الميادين، كأنها تميمة التوحد والنصر المبين ، وظنى أن ذلك ليس مردّه إلى أن جمال عبد الناصر كان منحازاً إلى القاعدة الاجتماعية المنتجة العريضة فحسب ، ولكن ظنى أنه فى النهاية ، كان أقرب إلى أن يكون التلخيص الفريد لهذه الحالة الفريدة التى أسمها ( الخصوصية المصرية ) ، التى تنحدر من هذا العمق الحضارى التاريخى لمصر .
إن ذلك لا يعنى أن جمال عبد الناصر فوق النقد ، وأن ثورة يولو فوق المراجعة النقدية ، وقد كنت أحد دعاة هذه المراجعة بين ضفتى كتاب ، ولكن ما يجرى لا هو بالنقد ولا هو بالمراجعة النقدية ، فقذف التاريخ بالأحجار ليس نقداً وليس مراجعة ، وتشويه وجوهه ليس نقداُ وليس مراجعة ، وضحد ميراثه الحىّ وذمه وتحقيره ليس نقداً وليس مراجعة ، لأنه فى مجمله ليس عملاً من أعمال المنطق ، ولا من أعمال الثورة ، ولا من أعمال العقل .
إن ميراثنا التاريخى العظيم كامن فينا ، سابح فى كريات دمنا ، وحين نجحده ، فإنما نجحد أنفسنا !

 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 أربعاء, 23 أبريل 2025
أربعاء, 23 أبريل 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 جمعة, 18 أبريل 2025
جمعة, 18 أبريل 2025 
 جمعة, 18 أبريل 2025
جمعة, 18 أبريل 2025 
 أربعاء, 16 أبريل 2025
أربعاء, 16 أبريل 2025 


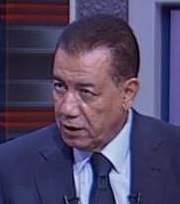

 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 


